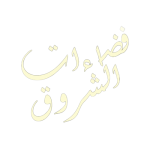“وإنك لعلى خلق عظيم”
هذا وصف الله لنبيه صلى الله عليه وآله، وهو سبحانه وتعالى القائل: “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”.
فإذا كان الرسول هو الأسوة الحسنة، والقرآن يصفه بأنه على خلق عظيم، فهنا نفهم أن على كل منا أن يكون على شيء من هذا الخلق العظيم.
وينبغي أن نفهم أن هذا الخلق العظيم هو غاية كبرى من غايات الإسلام، ومقصد مهم من مقاصد التشريع، ويجب أن نقتدي به في أعماله وأقواله وأخلاقه.
ويجب علينا أن لا نجتزئ من القدوة ما يعجبنا أو يوافق هواه فقط، فالتجزئة لن تحقق لنا المراد والغاية وهي التحلي بالخلق العظيم.
ولا يعني أن يكون الخلق العظيم هو كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، فهو من رباه ربه واصطفاه خالقه وجعله رحمة للناس كافة.
فالريب من الفرق ما، ولكن هذا الفرق لا يعني أننا لا نستطيع أن نكون على خلق عظيم بوجوه ما وبدرجات متفاوتة وإن لم تكن كاملة.
وهنا فلنتعرف على نموذج يبين لنا كيف أضعنا الغاية وتوجهنا للوسيلة، ولنحاول أن نرى ما هي النتيجة التي سنجنيها من ذلك:
فلننظر للصلاة مثالًا، وهي أبرز أركان الدين، كثير من المسلمين يؤديها والحمد لله، وكثير يحرص على النوافل والسنن المؤكدة.
ولكن سنجد كثيرًا من هذا الكثير، وقد اختلفت أحواله في حياته وساءت أخلاقه في معاملته.
فلماذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟
لماذا لم يصل إلى درجة الخلق المرغوب من الحسن؟
لأنه نسي أو تناسى غاية الخلق وغاية النهي عن الفحشاء، لأنه نظر للصلاة على أنها مجرد تكلفة تشريعية وواجب عليه أن يؤديه فيسقط عنه إثم الترك.
فما الذي يحدث له؟
نعم، قد يسقط عنه إثم الترك، ولكن عدم تحليه بالخلق الحسن، وإساءته لخلق الله، وسوء سلوكه في معاملة الناس، كل ذلك وأكثر سيجعله يقع في سلسلة من الآثام لا تكاد تنتهي.
وهنا سيقع فيما فر منه، وهو الوقوع في إثم، ولكن بدل أن يكون إثم ترك الفريضة سيكون إثم الإساءة وسوء الخلق، ويكون إثم تشويه صورة المصلي.
وكل ذلك لأننا نسينا أو تناسينا أو غفلنا، وتركنا الغايات والمقاصد من تشريع الله ومن إنزاله لدينه على البشر ورضاه لهم هذا الإسلام دينًا.
كل ذلك لأننا جزأنا ديننا وفصلناه عن حياتنا.
كل ذلك لأننا رضينا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض، كل ذلك لأننا نظرنا إلى الإسلام من جانب واحد فقط، هو جانب التكاليف الشرعية، وتركنا الجانب الأهم والأكثر، وهو النتيجة الحتمية لإقامة الجانب الأول، وهي الغاية التي شرعت من أجلها الجانب الأول.
كل ذلك لأننا تعاملنا مع الفرائض على أنها أعباء واجبة الإسقاط، لأننا نظرنا لها على أنها غايات علينا أن نؤديها، وأن نعرف طريقة أداء كل جزئية منها وما قاله الفقهاء فيها، وما اختلفوا أو اتفقوا عليه منها، وتركنا أعظم شيء وهو الغاية التي شرعت من أجلها.
غاية إدامة الصلة بالله، وتقوية الخشية منه، وتحسين مستوى الأخلاق والرقي بها، والتخلص من انشغالات الدنيا لدقائق صافية مع المولى من أجل تزكية النفس واتصال الروح بالعالم العلوي.
إن الدين متكامل، له غايات وله وسائل.
الغايات مثل: الرحمة والتقوى والتذكر وحسن الخلق.
والوسائل مثل العبادات والمعاملات: فرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج، وضوابط المعاملات المالية والتجارية والأحوال الشخصية والعقود، وسائر معاملاتنا اليومية، كلها يجب أن تخضع للتشريع الإلهي من أجل أن تحقق غايتها.
لكن إن لم ندرك أن غايتها هي إقامة الحياة الحقة وتشريع الإسلام سيادته، والتواصل بين الناس بالرحمة، والتسامح، والأمانة، وأخذ الحق للمظلوم، وإشاعة جو التآلف والعدل والصدق، ونصرة الضعيف، وتزكية النفس بالذكر والإيثار، والارتقاء بها عن الرذائل، وإقامة المجتمع على أسس ركيزة من التكافل ولتحاب وحفظ الهيبة والتوقي من الشرور،
فإن هذه الغفلة تجعلنا نتعامل مع العبادات معاملة جافة خالية من المقاصد، وهي التي تهوي بنا، وهي التي توقعنا فيما فررنا منه، وهي التي تجعل مجتمعاتنا تعاني الويلات.